أقلام الثبات
لم يطُل الوقت لتقييم حجم الردّ "الإسرائيلي" على إيران، وتطابق التوصيف بين وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، الذي شبَّه المسيرات "الإسرائيلية" التي استهدفت أصفهان، وكأنها ألعاب يلهو بها أطفال إيران، فيما اعتبر وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير، أن الضربة "الإسرائيلية" كانت هزيلة بالمقارنة مع الهجوم الإيراني الذي دمَّر قاعدتين أساسيتين للقوات الجوية "الإسرائيلية"، وأدى الى مقتل بضعة جنود، وكان من الطبيعي أن يصدر اعتراضات من مجلس الحرب على تصريحات بن غفير التي اعتُبرت غير مسؤولة ومُحبِطة للمعنويات.
على اية حال، سبق وأٌجريت مقارنات جيو - سياسية بين دولة تترامى على أكثر من مليون ونصف المليون كيلومتر مربع مثل إيران، وكيانٍ محتلّ لأرض فلسطينية مساحتها 22 ألف كيلومتر مربع، وليس هناك من داعٍ للتكهنات في حال نشوب حربٍ إقليمية يشارك فيها الطرفان، لأننا حتى ولو قرأنا التاريخ، عن الإمبراطورية الفارسية، ولاحقاً عن الجمهورية الإسلامية في إيران، فلا مجال أيضاً للمقارنة بين كيان قومي أممي عقائدي، مع كيانٍ من قبائل متنافرة تم استيرادها من الغرب والشرق لإنشاء "دولة" تُجاهر بإعلان نفسها يهودية في محيطٍ يعتبرها جسماً غريباً، لا يستر عوراته لا الغطاء الإبراهيمي المُصطنع، ولا مَن يؤمن من العرب بوحدة الديانات الإبراهيمية ستاراً للتطبيع المُريب مع كيان بغيض، جُعلت له فلسطين موطناً بديلاً عن الأرجنتين وأثيوبيا.
وأزمة الكيان الصهيوني بعد عملية طوفان الأقصى، ليس لأنه دخل لعبة الكبار حيث تُرسم خرائط الدول خلف الأبواب المغلقة، بل لأن مقاتلاً مقاوماً في أنفاق غزة، مع مقاومٍ من اليمن أو العراق أو لبنان، باتت بندقيته هي التي تُرسِّم الحدود العادلة، وهي التي تُعيد ترسيم خرائط وضعها منذ 75 عاماً مَن كانوا كباراً قبل نشوء محور المقاومة في الشرق الأوسط.
وبصرف النظر عن السياسة العدوانية الأميركية ومَن يتبعها من حكومات دول الغرب، وقوافل التمويل والتسليح والتذخير بحراً وجواً، التي تتدفق لدعم "إسرائيل"، وكان آخرها إقرار 26 مليار دولار من الكونغرس الأميركي، ونتساءل، هل ما بقي من غزة وتحديداً محافظة رفح يضمن للكيان الصهيوني إعلان النصر؟ وأي نصرٍ تحقق بعد الإخفاق في الوصول الى قيادات المقاومة الميدانيين، والفشل في العثور على الرهائن، فيما المقاومة الفلسطينية تُعيد في أية لحظة المواجهة الى بيت حانون في أقصى الشمال، ومدينة غزة في الوسط، وبالتالي، كما تنتقل المقاومة في الأنفاق من الشمال الى الجنوب وبالعكس، هكذا هو حال الرهائن، مع استخدام المقاومة شبكات هذه الأنفاق من تحت أنقاض قطاع غزة، لاصطياد "الإسرائيليين" عديداً وعتاداً، في عمليات "الذئاب المنفردة" التي لن تتوقف قبل إنهاء حكومة نتانياهو عدوانها.
وشعب الكيان الصهيوني على حق عندما يُحمِّل نتانياهو المسؤولية الكاملة، ليس فقط في الفشل الاستخباري الذي سهَّل عملية طوفان الأقصى، ولا الخيبة العسكرية لجيش "الدفاع" في المناورات البرية على امتداد القطاع، دون القضاء على المقاومة ولا تحرير الرهائن، بل أيضاً في رهان نتانياهو على مقولة "اليوم التالي" أنها ستكون لصالح كيانه، ووافقته دول كبرى مع دول عربية وازنة، أنه من السهل إجراء "ترانسفير" لنقل مليوني فلسطيني الى الخارج الإفريقي البعيد في إثيوبيا، أو الجوار المصري القريب في صحراء سيناء، وهنا حصلت الصدمة الصهيونية، بأن "اليوم التالي" لن يكون سوى بقاء أبناء غزة في غزة ولن يحكمهم أحد سوى أنفسهم.
ثلاثة خيارات طُرحت لتحديد مصير قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى، وجميعها تناولتها مفاوضات إقليمية ودولية وتداولها الإعلام بإسهاب، وسط الحمم التي كانت ولا زالت تنهمر على المدنيين الفلسطينيين. الخيار الأول كان تهجير أو تسفير سكان القطاع، والثاني احتلال القطاع من الجيش الإسرائيلي، أو استقدام قوات عربية بإشراف أممي لإدارة شؤونه في مرحلة ما بعد حماس، والخيار الثالث إقامة دولة فلسطينية لإنهاء الصراع ضمن خطة إرساء سلام طويل الأمد في الشرق الأوسط، لا يتحقق قبل حصول الفلسطينيين على حقوقهم بدولة.
وليس مستغرباً إعلان بعض الدول حالياً عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، التي أُعلِن عن قيامها في 15نوفمبر 1988 في الجزائر، بجلسة استثنائية في المنفى للمجلس الوطني الفلسطيني، وقد تم الاعتراف بهذا الخبر بسرعة من قبل عدد من الدول، وبحلول نهاية العام، تم الاعتراف بالدولة من قبل أكثر من 80 دولة في فبراير 1989، الى أن حصلت اتفاقية أوسلو عام 1993 وأزهقت روح الدولة الوليدة لأكثر من سبب، ورغم بلوغ عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين 138 دولة في منتصف العام 2019، لكن الأحادية الأميركية المُكابرة، حتى في كواليس الأمم المتحدة ومجلس الأمن، هي التي عرقلت مسار التفاوض الندٍّي بين الفلسطينيين و"إسرائيل".
أما وقد باتت دولة فلسطين أمراً واقعاً مهما طال وقت التسويف الصهيوني، فإن قيام هذه الدولة هو الخيار الثالث والأخير والنهائي، بعد سقوط الخيارين: الأول القاضي بتهجير أبناء قطاع غزة، والثاني الذي يَُبيح حكم غزة للمحتل أو مَن ينوب عنه من "عرب الاعتدال"، والشعب الفلسطيني الذي رفض هذين الخيارين وتمسك بالصمود رغم أهوال الموت والدمار اليومية، هو حائزٌ حكماً على حقه بدولة ولكن، العالم بانتظار إعلان وحدة القوى السياسية والعسكرية الفلسطينية، كي لا تُبعث مهزلة أوسلو من جديد، على حساب شعبٍ دفع تضحيات أقل ما يُقال عنها أنها أسطورية.








 أدوات أمريكا تتفكّك وتتصارع لتقسيم سوريا ــ د. نسيب حطيط
أدوات أمريكا تتفكّك وتتصارع لتقسيم سوريا ــ د. نسيب حطيط  طوفان "العهد الصادق": إيران تُسقط أوهام الغطرسة وترسم خارطة السيادة
طوفان "العهد الصادق": إيران تُسقط أوهام الغطرسة وترسم خارطة السيادة 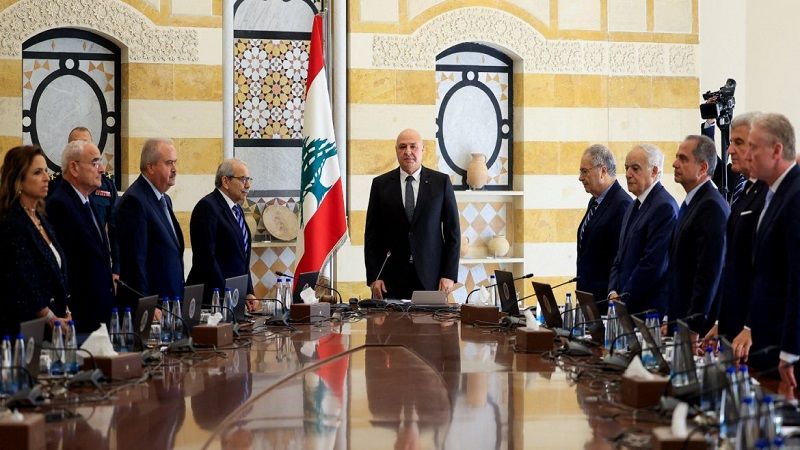 هل يُعاد إنتاج "النموذج السوري" في لبنان؟ ــ د. ليلى نقولا
هل يُعاد إنتاج "النموذج السوري" في لبنان؟ ــ د. ليلى نقولا  المشروع الأمريكي: نزع السلاح مقابل لا شيء! ــ د. نسيب حطيط
المشروع الأمريكي: نزع السلاح مقابل لا شيء! ــ د. نسيب حطيط 






