أقلام الثبات
يكرر خطاب التحريض الطائفي والعنصري لغة الحرب الأهلية، التي جربها اللبنانيون في حقب عديدة، أبرزها المرحلة التي سبقت إعلان ما أسماها بشير الجميل: "حرب تحرير لبنان من الغرباء" عام 1975. وما حوادث الكحالة المتكررة، التي أعطاها البعض رمزية معينة، إلا محطة على هذه الدرب، في ما تحمله من مشاعر العنجهية والتسلط والإستئثار.
قبل وقوع حادثة الكحالة الأخيرة، كانت لافتة تصريحات رئيس أبرز الأحزاب المحرضة على تلك الحادثة، اعتبر في أحدها "أن الحل الوحيد يكمن في إنتخاب رئيس جديد للبنان، قادر على إعادة تشكيل السلطة". ورفض في تصريح آخر الرئيس التوافقي أو الوسطي. وطالب برئيس مواجهة، في إصرار فئوي على التفرد بالسلطة والتسلط على اللبنانيين والإستئثاربالحكم، من قبل أحد أكثر تلامذة بشير دموية وإجراماً. وكأنه بتلك التصريحات يعلن نفض يده من إتفاق الطائف؛ وسعيه الجدي للعودة بالبلاد إلى ما قبل ذلك الإتفاق، الذي لم تطبق بنوده كلها، على الرغم من أنه أوقف حرباً اهلية دامت خمسة عشر عاماً.
وهذا الخطاب الإنقلابي على إتفاق الطائف، يشكل رداً قوياً على الداعين للتمسك بذلك الإتفاق، بل وقطع للطريق على تنفيذ ما لم ينفذ منه بعد، بعد تجميدها طوال أكثر من ثلاثين عاماً. ولا يخفي هذا الخطاب الحنين والسعي للعودة إلى صيغة "الرئيس ومعاونوه"، التي تصارعت لعقود خلت، مع المطالبة بالمشاركة، لأن رئيس الحكومة في ذلك الوقت كان مجرد "باش كاتب" عند رئيس الجمهورية. وكان الوزراء برتبة موظفين طوع أمره.
ومثل هذا الخطاب يريد إعادة لبنان إلى حكم رئاسي، كان يضع قناعاً برلمانياً هشاً لا يقدم ولا يؤخر. ولمن تسعفه الذاكرة، أو قرأ عن تلك المرحلة، فإن توقيع ثلاثة وخمسين نائباً، من أصل تسع وتسعين، أي الأكثرية المطلقة؛ على عريضة تطالب باعادة 110 أساتذة رسميين طردوا من وظيفتهم، لأنهم نظموا إضراباً مطالبين بتحسين رواتبهم، في بداية سبعينيات القرن الماضي، لم تدفع رئيس الجمهورية في ذلك الوقت سليمان فرنجية (الجد)، إلى إعادة الأساتذة، بل كان مصير عريضة النواب سلة المهملات.
والواقع أن مثل هذه المطالبات تعاكس المسار الطبيعي لبلد مثل لبنان، الذي أما أن يواصل مسيرة خوض حروب داخلية كل عشر أو خمس عشرة سنة، أو يدخل مسار تطور يسير به نحو نظام ديموقراطي حقيقي، يعامل شعبه حسب الكفاءة وبقدر ما يخدمون وطنهم، بغض النظر عن الدين والطائفة، باعتبار أن علّة لبنان هي في نظامه الطائفي، القائم على المحاصصة، التي ترتكز بدورها على الزبائنية، التي حكماً تنتج فساداً في السلطة وتمييزاً بين المواطنين؛ وتدفع الناس إلى التذمر والتأفف وصولاً إلى الثورة وممارسة العنف كلما سنحت لهم الفرصة، أو إلى الهجرة التي جعلت معظم اللبنانيين مغتربين.
والحقيقة التي يتهرب منها كل من يشارك في الحكم في لبنان، أنه أسير الخطاب الشعبوي الفئوي والطائفي، بغض النظر عن قناعاته، أو شعاراته. فحماية المحاصصة والدفاع عن "الحقوق في جبنة الحكم" ورعاية الزبائنية وتوسيعها، تحتم إعتماد خطاب شعبوي متطرف، لا تكفي كل مساحيق الشعارات عن الوطن والسيادة والعيش المشترك في تغطية بشاعته. وما جعل بلدة آمنة مثل الكحالة "متراساً" لمجموعات عنصرية متطرفة إلا تعبير عن هذا الواقع. ومن يعرف الكحالة عن قرب، يدرك كم أن معظم أهاليها هم خارج هذا التصنيف الذي يفرض عليها، فيما القلة من أهلها تواكب التطرف والتعصب، مثل كل بلدات لبنان وطوائفه. وأكبر خدمة لهذه القوى الدموية والعنصرية هو التعميم، فما يجري منذ عقود على كوع الكحالة، هي جرائم ارتكبت وترتكب بحق المارة على طريق دولية، تنفذها أحزاب وقوى ميليشياوية؛ وليس الأهالي. ورمزية كوع الكحالة الحقيقية، أن هناك من يأخذ هذه البلدة أسيرة ويحولها لكمين دائم، ليفرض من خلاله افكاره ومواقفه التسلطية، إنطلاقاً من قناعته بأن لبنان له وحده؛ وهو أما يحكمه على مزاجه أو يحرقه على من فيه.








 سلطة الشرع: تركية شمالاً وصهيونية جنوباً… وتكفيرية في كل سوريا ــ أمين أبوراشد
سلطة الشرع: تركية شمالاً وصهيونية جنوباً… وتكفيرية في كل سوريا ــ أمين أبوراشد  أدوات أمريكا تتفكّك وتتصارع لتقسيم سوريا ــ د. نسيب حطيط
أدوات أمريكا تتفكّك وتتصارع لتقسيم سوريا ــ د. نسيب حطيط  طوفان "العهد الصادق": إيران تُسقط أوهام الغطرسة وترسم خارطة السيادة
طوفان "العهد الصادق": إيران تُسقط أوهام الغطرسة وترسم خارطة السيادة 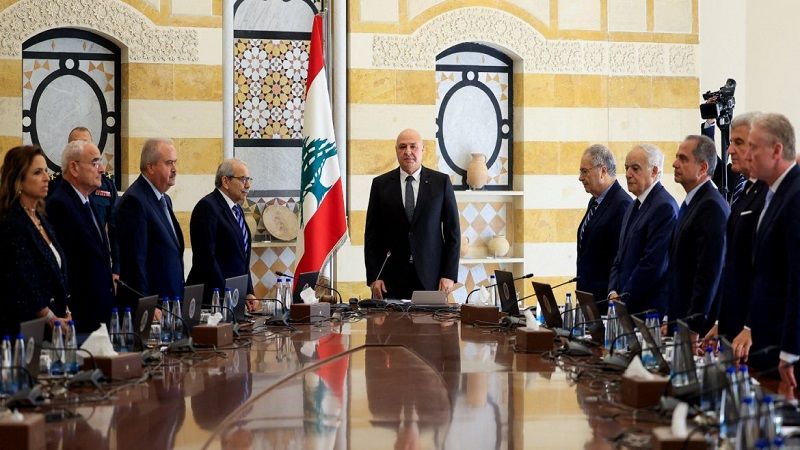 هل يُعاد إنتاج "النموذج السوري" في لبنان؟ ــ د. ليلى نقولا
هل يُعاد إنتاج "النموذج السوري" في لبنان؟ ــ د. ليلى نقولا 






