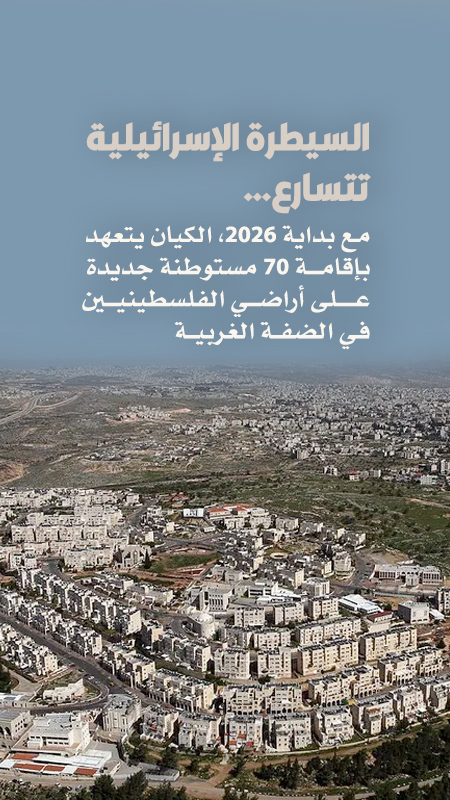الثبات - التصوف
الحكم العطائية
"لا تطلبنَّ بقاء الواردات بعد أن بسطت أنوارها، وأودعت أسرارها، فلك في االلهِ غنى عن كلِّ شيء، وليس يغنيك عنه شيء"
يقرر ابن عطاء الله في الحكمة أنَّ الواردات بحد ذاتها ليست دليلَ قربٍ ولا بُعْدٍ، وإنَّما الذي يجعلها دليل قرب من الله تعالى ثمارها المتمثلة في الأخلاق الرضية والسلوك المستقيم على صراط الله تعالى، فالعبرة إذن بما تحمله إلى صاحبه من ثمار، وليست العبرة بما تتركه في النفس من أنوار وآثار.
ويقرر أنَّ على السالك، حتى عندما تحقق الواردات فيه ثمارها، وتودع في كيانه أسرارها، ألَّا يركن إليها ويطلب بقاءها، فإنَّه إن ركن إليها واستأنس بها ورغب في بقائها، فذلك دليل واضح منه على أنَّ له بها شغلاً عن الله وأنَّه إنَّما يستأنس بها ويتمنى دوامها لرغبة في ذلك تعود إلى نفسه وحظوظها.
وإني لأرى حال من يلذّ له ورود الواردات، وتركن نفسه إليها، ويستوحش لها إنَّ غابت، أشبه ما يكون بحال من وفاه ساعي البريد يحمل إليه هدية من صديق عزيز، فلم يكتف بأن يكرم وفادته ويشيعه شاكراً، بل تعلق به واستبقاه لديه واتجهت منه العواطف إلى شخصه، ناسياً الهدية والصديق العزيز الذي أرسلها إليه وخصه بها!..
في الناس من إذا دخل في الصلاة، تلمس أسباب الخشوع ومشاعر الرقة، بشتى الوسائل، وتلمُس أسباب ذلك بحد ذاته مبرور ومطلوب، فإنَّ الخشوع روح الصلاة وسرّها المكنون، ولكن المبتغى منه أن يكون المصلي مع الله في قراءته ومناجاته ودعائه له، فإن ركن المصلي إلى حالة الخشوع واستأنس بها، فقد انفصلت بذلك عما تقصد من أجله، وغدت حظاً من حظوظ النفس، ولعل المصلي يرى في تلك الحالة التي انتابته دليلاً على قربه من الله وعلى محبة الله له، فيداخله السرور لذلك، وتغدو هذه الحالة عندئذٍ أمنية ينتظرها ويتكلف لها، ليمتع نفسه منها بهذا السرور، فقد انقطع الخشوع إذن، في حسابه وقصده، عن الغاية التي كان ولا يزال سبيلاً إليها، بل ربما أصبح الخشوع نفسه شاغلاً له عن حقيقة الحضور مع الله في الصلاة، وفي الناس من يتحدثون كثيراً عما يعبرون عنه بالتجلي الذي يشعرون به في مجالس ذكر، أو مجالسة شيوخ، او تلاق على دراسة للسيرة النبوية أو الصلاة على رسول الله ومدحه وذكر شمائله مثلاً..
ولا ريب أن حدوث التجلي بحد ذاته يغلب أن يكون دليلاً على صفاء القصد من الجالسين وعلى القبول والرضا من الله عزَّ وجل عن العمل الذي اجتمعوا من أجله، ولكن شأن كثير من هؤلاء الناس، أن تتحول مسألة التجلي هذه لديهم إلى هاجس يشغل بالهم، وإلى رغبة ذاتية يجتمعون عليها ويتنادون من أجلها، وربما استعادوا فيما بينهم -بعد انتهاء المجلس- مشاعر التجلي الذي اجتاح مجلسهم وهيمن عليهم، وكثيراً ما ادعى مدعون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر بنفسه مجلسهم، وأن أحد الأولياء الصالحين، شملهم بروحانيته وطيفه!..
وزبدة ذلك أنَّ حظوظ النفس هي التي تحجب الإنسان عن ربه جل جلاله، ثمَّ إنَّ هذه الحظوظ تتنوع حسب حال الإنسان ومشربه ونوع سلوكه، فمن كان شارداً في سلوكه عن آداب الشرع وأحكامه، تمثلت حظوظه النفسية في الأخلاق المذمومة كالكبر والعجب والحسد والتكالب على المال وارتكاب المحرمات، ومن كان متقيداً في سلوكه بأحكام الشرع وآدابه، تمثلت حظوظه النفسية في آفات خفية لا تبدو على ظاهر السلوك، بل ربما كانت معدودة في ظاهرها من القربات ودلائل الرقي في مدارج السلوك إلى الله، مثل هذا الذي يحذر ابن عطاء الله، بل يبالغ في التحذير منه، وهو ركون السالك إلى الواردات التي قد يتجلى الله بها على قلبه، وفرحه بها واتخاذها غاية لمجهوداته وأذكاره وقرباته، فرب شهوة جاءت مقنعة بقناع الدين مكسوة بثوب العبادة والإرشاد، وبالتالي يكون فرح الشيطان بها أكثر وأثر الغواية بها أبلغ.
ولكن فما العلاج الذي يشفي السالك من هذا الوباء؟
علاجه أن ينمي مشاعر عبوديته لله تعالى وذلك بأن يعود دائماً إلى مرآة ذاته ليستجلي فيها هويته، فإنه إن فعل ذلك أيقن ابتداء وجوده بالله، وأن استمرار وجوده بالله، وأن سائر صفاته من الله، وأن جميع تقلباته بالله، وأنه من دون الله لا شيء.
لعلك تقول: وهل في المسلمين الصادقين من لا يعلم هذه الحقيقة؟
والجواب: أنَّ العلم الذي يقصد به حفظ المعلوم في الذهن شيء، واصطباغ العالم به وتفاعله معه شيء آخر، لا يكفي أن تغرس هذه الحقيقة في فكرك ثم تودعها في قاع عقلك، بل لابدَّ أن تجعل لها سلطاناً على كيانك كله، فبذلك ترقى إلى سدة العبودية لله، ولا يتأتى هذا إلا بالإكثار من مراقبة الله وذكره..
إن العبد لا يتلهّى بالواردات مستأنسا بها إلا وهو يرى فيها شريكاً مع الله عز وجل، وفي ذلك ما يحجبه عن حقيقة توحيده لله، وصادق عبوديته له، إذا إن كمال كل من التوحيد والعبودية له يهتف في سرك قائلاً: "إن لك في الله غنى عن كل شيء، وليس يغنيك عنه شيء".








 العَجَبُ كُلُّ العَجَبِ… حين يهرب الإنسان من مصيره
العَجَبُ كُلُّ العَجَبِ… حين يهرب الإنسان من مصيره  ماهو التصوف؟؟؟
ماهو التصوف؟؟؟  بماذا عرفت الله ؟؟؟
بماذا عرفت الله ؟؟؟  حقائق عن التصوف...الورع عند الصحابة والتابعين
حقائق عن التصوف...الورع عند الصحابة والتابعين