أقلام الثبات
لسنا بوارد مقارنة التوازن بين القوى في العدوان على غزة، بل بين الباطل المُدجَّج بفولاذ الدبابات والبوارج والطائرات، والحق الذي لم يترك له الباطل سوى الصمود والمقاومة على الأرض العراء.
رغم كل الذي يحصل من البر الفلسطيني الى البحر الأحمر، نستقي نتائج العدوان الأميركي الصهيوني منذ الآن ومهما طال أمده، ما دام الشعب الفلسطيني الصابر ينزح من غزة الى غزة، وأسقط كل العروضات المُسقِطة لحقوقه في دولته، سواء كانت عبر مؤامرة التهجير إلى سيناء كأرضٍ بديلة، أو ضمن بازار الهجرة الطوعية أو القسرية لترحيل أبناء غزة الى أصقاع الدنيا كما يهذي وزير الأمن
الصهيوني إيتمار بن غفير، أو زميله وزير المالية بتسلئيل سوميتريتش، ولعل أولى ثمار نصر غزة ستكون تطيير حكومة بنيامين نتانياهو بكل ما تحوي من يمينيين وعنصريين ومتدينين، سقطوا قبل أن يسقط باب نفقٍ واحدٍ لحركة حماس والمقاومة الفلسطينية على طول القطاع من بيت حانون حتى رفح.
سيدة فلسطينية قالت بعد قصف مركز الإيواء الثاني الذي لجأت إليه مع عائلتها في محافظة رفح: دمروا منزلنا في بيت حانون، وانتقلنا الى مخيم جباليا كي لا نبتعد كثيراً عن شمال القطاع، ثم نزحنا الى الجنوب نتيجة القصف، وسقفنا ليس أكثر من خيمة و"زنانة" تبحث عن أي كائن حيّ، فإذا كان هذا قدرنا في النزوح، نريد أن نعود الى مسقط رأسنا بيت حانون، وأن ننصب خيمة على ركام منزلنا.
مأزق أميركا وغالبية الدول المُتحالفة معها، أنها اختبرت ما أرادت من أسلحتها في ساحات الشرق الأوسط، من صنعاء الى بغداد ودمشق ووصولاً الآن الى دعم العدوان على غزة والضفة الغربية، واشتعلت الاحتجاجات الشعبية في شوارع الدول الكبرى، لأن ترسانات الاستكبار كبيرة جداً على ساحات مواجهة كهذه، سواء نزح اليمني الفقير من هذه المحافظة أو تلك في بلاده، أو كما ينزح أبناء غزة الآن، بحيث لم يعُد لدى اليمني ما يخسره، ولا لدى الفلسطيني الباحث عن خيمة في أرضه تقاوم باللحم الحي إجرام "زنانة صيد البشر"، وأقصى ما يرتضيه المقهور في أرضه المحتلة، قطرة الماء وبعض الغذاء بعد أن مُنع عنه الأمان وحبة الدواء.
فرقاء أزمة غزة يندرجون تحت معادلة ثلاثية لا رابع لها:
أميركا وبعض الغرب، و"إسرائيل" ومعها بعض العرب "الإبراهيميين" الذين لا يقلِّون صهينةً عنها، والشعب الفلسطيني وخلفه محور المقاومة.
أولاً: أميركا ورطتها الكبرى هي في البحر الأحمر، واستقدام بوارجها بعد عملية طوفان الأقصى، كان بغرض الاستعراض أمام إيران دعماً للكيان الصهيوني، فوجدت نفسها في مواجهة قوات أنصار الله اليمنية التي انتفضت "باليستياً" بمواجهة كل باخرة وجهتها الكيان الصهيوني لحين فك الحصار عن قطاع غزة، وباتت أميركا ومعها الدول العشر التي غدت عشرين في تحالفٍ لحماية الملاحة الدولية، بين فكَّي كماشة إيرانية - يمنية فيما لو سوَّلت لها نفسها عسكرة البحر الأحمر.
المصادر الميدانية اليمنية تُفيد من واقع الأرض أن "إسرائيل" زجَّت بالولايات المتحدة الأميركية في مستنقع البحر الأحمر، فيما السعودية تخلصت من الهمّ اليمني الكبير الذي يؤرقها، وأن أسباب سحب أميركا لحاملات الطائرات والبوارج الحربية مداورةً، هي عملية إعادة انتشار وتموضع في المناطق الإستراتيجية الخلفية، حتى لا يتم استهدافها من قبل القوات اليمنية، التي تمتلك مخزونا كبيرًا جدًا من الصواريخ المتعددة الاستخدامات، علاوة على أسراب كبيرة جدًا من الطائرات المسيرة التي تستطيع تشويش وإشغال منظومات الباتريوت الأميركية، ثم استهدافها بصواريخ بحرية يمنية.
الجزء الثاني من الورطة الأميركية، أن الحضور الغربي في البحر الأحمر لم يُخفِّض نسبة الخطر على الملاحة بين آسيا وأوروبا، ولا أسعار بوالص التأمين، بدليل أن عملاق الشحن البحري العالمي التي هي شركة "ميرسك" الدانماركية، أعلنت التوقف عن استخدام منطقة البحر الأحمر حالياً، ووجَّهت قوافل السفن العائدة لها الى رأس الرجاء الصالح، وتبعتها مئات شركات الشحن في هذا الإجراء، رغم ارتفاع الكلفة والتأخير في آجال التسليم.
وبانتظار أن ينجح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في إقناع الحكومة الصهيونية بالانتقال الى المرحلة الثالثة من الحرب والسماح لسكان شمال غزة بالعودة، كما قال عند وصوله الإثنين الى تل أبيب، فإنه أعلن يوم الأحد من الدوحة عن أولوية أميركا المتمثلة بإعادة مفاوضات إطلاق سراح الرهائن من جهة، وتزخيم إدخال المساعدات الى قطاع غزة، ربما "اتقاء لشر أنصار الله"!.
ثانياً: "إسرائيل" التي خسرت أمنية قديمة بإخلاء غزة من سكّانها وإقامة "ريفييرا" على شواطئها، وهذه الأمنية لم ولن تتحقّق ما دام الغزّيون يقاومون ويستميتون في الدفاع عن أرضهم، لكنّ خيار التهجير القسري أو الطوعي لأهل القطاع باقٍ على جدول أعمال قادة الكيان، وهُم يريدون استباحة الأرض كما استباح أسلافهم من قبل أجزاء واسعة من فلسطين، وإذا لم يتحقّق حلمهم التوسّعي كما اشتهى الآباء المؤسّسون للمشروع الصهيوني، فإنّهم يبحثون عن بدائل لتثبيت الاحتلال، لكنّهم يخشون العودة إلى القطاع وفرض احتلالهم المباشر كما كان الحال قبل انسحابهم عام 2005، لذا هم يبحثون عن وسيط أو وكيل لحكم الغزّيين وإدارة شؤونهم ورفع عبئهم عن كاهلهم، على أن يكون شريكاً مطيعاً لهم.
هٌم يصرّون على إنهاء حكم "حماس"، ولا يبالون بالسلطة الفلسطينية في الضفة، والسلطة بالنسبة إليهم باتت ضعيفة وبلا صدقية، السلطةُ التي سقطت في الامتحان "الإسرائيلي"، بل ورسبت في كلّ الاختبارات التي تؤهّلها لأن تكون شريكاً، وهي بالكاد تستطيع السيطرة على أجزاء من رام الله، فكيف في استطاعتها لجم تمرّد غزة وعنفوانها بعد الحرب المجنونة والدمار الهائل الذي حلّ بها؟
الحل النهائي لغزة ما بعد الحرب هو من وجهة النظر الصهيونية الحالية، تفعيل حكم العشائر الموالية للكيان "الإسرائيلي" وهي تُعرف بتسمية "الحمائل".
وبالفعل، كشفت "إسرائيل" عن خيارها البديل لإدارة القطاع إذا ما تمكّنت من القضاء على حركة حماس، وأنها ترمي الى إرجاع الفلسطينيين إلى الحكم القبلي وتحكيم العشائر الموالية لأجهزتها الأمنيّة بمصيرهم وأحوالهم.
وأفادت "هيئة البثّ الإسرائيلية" أنّ الجيش أعدّ خطة لتوزيع المعونات الإنسانية على سكان قطاع غزة، تتولّى بموجبها عشائر كبيرة تُعرف محلّياً باسم "الحمائل" إدارة وتوزيع هذه المساعدات الإنسانية في القطاع، ووصفت الهيئة تلك الحمائل بأنّها "معروفة لدى جهاز الأمن العام (الشاباك) ولدى الأهالي في القطاع"، وذكرت أنّ القطاع سيُقسم إلى محافظات ومحافظات فرعية تسيطر كلّ عشيرة أو عائلة كبيرة على إحداها، مع الإشارة إلى أنّ العائلات الكبيرة ستدير الحياة المدنية في القطاع خلال الفترة الانتقالية التي ستلي الحرب إلى حين ترتيب إدارة دائمة للقطاع.
و"الحمائل" أو العشائر كان لها دورها في مجمل التاريخ الفلسطيني، وكان لها تأثير كبير في تماسك المجتمع والحفاظ على الهويّة الثقافية، واضطلعت بأدوار مهمّة في عمليات الضبط الاجتماعي بغياب المؤسّسات الجامعة الكبيرة، وتمكّنت الحامولة الفلسطينية من ملء الفراغ، فتحوّلت في لحظة ما إلى سلطة تشريعية وقضائية وتنفيذية في آن معاً.
صحيح أن الحمائل تولّت الاشتباك مع المحتلّ الإنكليزي بعد خروج العثمانيين، لكنّها كانت أيضاً سيفاً ذا حدّين في ثورة 1936، حيث تمكّن المحتلّ الإنكليزي من إخماد الانتفاضة بأساليب عدّة من أهمّها الانشقاقات والتناقضات العشائرية وهي خلافات لم تتوقّف يوماً، وربّما كانت واحداً من أسباب كثيرة لانتصار المشروع الصهيوني. ذلك أنّ المجتمع الفلسطيني لم يستطع أن يبلور تمثيلاً سياسياً كليّاً جامعاً للأهداف والمطالب، الأمر الذي عزّزته أطراف كثيرة لتفكيك وحدة الشعب الفلسطيني باعتباره مجرّد "حمائل" أو طوائف أو جماعات.
وإذ استغلّت الحركة الصهيونية الصراعات "الحمائلية" لتعزّز سيطرتها السياسية الأمنيّة على مفاصل المجتمع الفلسطيني، وكان ذلك في مناطق 1948 ومناطق 1967 فيما بعد، فمن اللحظة الأولى للاحتلال عام 1967 بحثت إسرائيل عن قيادات "حمائلية" لتعزيز حضورها، ولتكون بديلاً أو خصماً للفصائل الفلسطينية التي خرجت من أجل النضال الوطني ضدّ المحتلّ.
وإذ كشفت "إسرائيل" عن خيارها البديل لإدارة القطاع إذا ما تمكّنت من القضاء على "حماس" وإنهاء حكمها، فهي تريد حكم "الحمائل" وإرجاع الفلسطينيين إلى ما قبل قيام القوى والفصائل، وإعادتهم إلى الحكم القبلي وتحكيم العشائر الموالية لأجهزتها الأمنيّة بمصيرهم وأحوالهم.
ثالثاً وأخيراً: الشعب الفلسطيني وخلفه محور المقاومة أمام فرصة تاريخية لم تحصل منذ 75 عاماً لقيام الدولة الفلسطينية، سواء من خلال المقاومة اليمنية للاحتلالات، وما تحققه المقاومة العراقية في دكّ القواعد الأميركية في شمال وشرق سوريا، وما يمكن للمقاومة في لبنان أن تحققه في لعبة توازن الرعب والردع مع العدو، وقدرة صمود المقاومة في غزة التي بلغت نسبة الشهداء والمصابين والمفقودين فيها 4% من سكانها، ودمار أكثر من 70% من المباني المدنية والبنى التحتية، فإن استمرار تحقيق الأهداف بمواجهة العدوان الصهيوني هو المطلوب، كي لا تكون غزة ومعها الضفة الغربية، رهائن حكم "المستعربين" من عملاء الكيان، أو العودة إلى حكم الحمائل و"بيوت الطاعة"، خصوصاً أن الداخل الصهيوني في أسوأ حالاته على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو أعجز من أن يُعيد نازحيه الى مستوطنات غلاف القطاع وعلى الحدود الشمالية مع لبنان.








 أدوات أمريكا تتفكّك وتتصارع لتقسيم سوريا ــ د. نسيب حطيط
أدوات أمريكا تتفكّك وتتصارع لتقسيم سوريا ــ د. نسيب حطيط  طوفان "العهد الصادق": إيران تُسقط أوهام الغطرسة وترسم خارطة السيادة
طوفان "العهد الصادق": إيران تُسقط أوهام الغطرسة وترسم خارطة السيادة 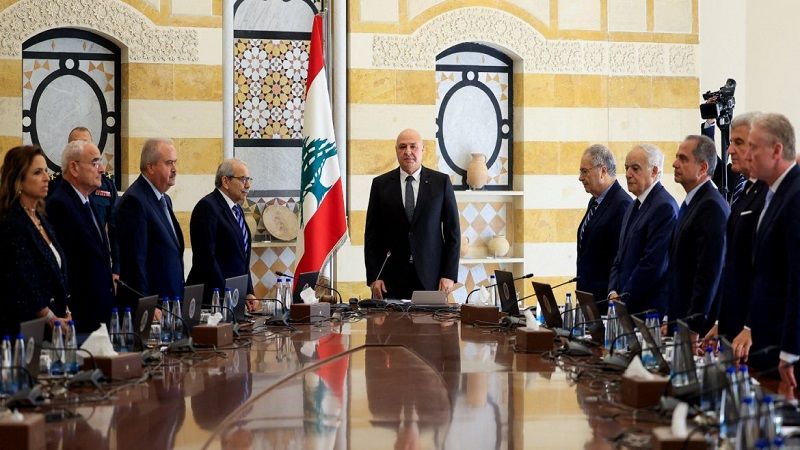 هل يُعاد إنتاج "النموذج السوري" في لبنان؟ ــ د. ليلى نقولا
هل يُعاد إنتاج "النموذج السوري" في لبنان؟ ــ د. ليلى نقولا  المشروع الأمريكي: نزع السلاح مقابل لا شيء! ــ د. نسيب حطيط
المشروع الأمريكي: نزع السلاح مقابل لا شيء! ــ د. نسيب حطيط 






