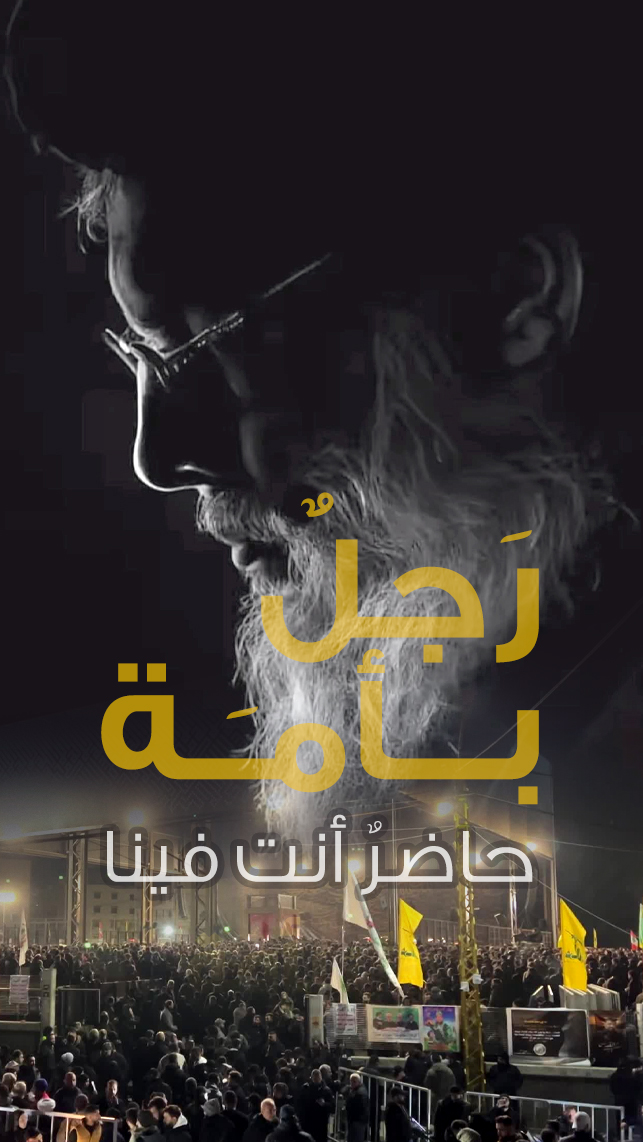الثبات ـ لبنان
منذ اتفاق الطائف عام 1989 حتى اليوم، واللامركزية الإدارية تشكل العنوان الأبرز الذي لا ينفك رجال السلطة بالحديث عنه باعتباره حاجة وطنية ملحّة، وليس مطلباً لفئة واحدة من اللبنانيين من أجل تعزيز المشاركة المحلية لجميع الفئات على تنوعها. فهذا المطلب هو من أهم البنود الإصلاحية التي يجب البت بها، إذ إنها العامل الأساسي في عملية الإنماء. لكن، ماذا نعرف عن اللامركزية، وهل أسهمت حقاً في الإنماء المتوازن للمناطق؟
اللامركزية الإدارية
اللامركزية الإدارية هي نوع من التنظيم الإداري للدولة، فهي تعتمد إما الـمركزية أو اللامركزية، تبعاً للنظام السياسي الذي تنتهجه والأهداف التـي تطمح إلى تـحقيقها، وتبعاً للمسؤوليات الـملقاة على عاتقها. فاللامركزية الإدارية هي نظام يعتمد على توزيع السلطة الإدارية واتخاذ القرارات على مستوى محلي أو إقليمي بدلاً من ترك هذه الصلاحيات بشكل مركزي. ففي لبنان تُعتمد اللامركزية على صعيد السلطات المحلية فقط أي البلديات. إن تطبيق اللامركزية الموسعة في لبنان له تأثيرات عدة ومنها: تعزيز المشاركة المحلية، تقليل التوترات السياسية، تحسين الخدمات المحلية، تعزيز التنمية المستدامة.
لكن هناك عقبات تقف في وجه تطبيق اللامركزية الموسعة ألا هي: التوترات الطائفية، صعوبة التمويل الكافي للسلطات المحلية، ضرورة إصلاح القطاع العام، ضرورة تطوير القدرات المحلية، التوازن بين الوحدات المحلية واستقرار وحدة الدولة، والتحديات الأمنية.
اللامركزية الإدارية وعملية الإنـماء الـمتوازن
منذ التسعينيات واللبنانيون يسمعون عن الإنماء المتوازن. لكن هل هناك فعلاً في لبنان إنماء متوازن، أو إمكانية لتحقيق الإنماء المتوازن؟
عانى لبنان من خلل في عملية التنمية، وقد تـجلى ذلك في التفاوت الـهائل في مستوى التنمية بين العاصمة بيروت وبقية المناطق وبالأخص الـمناطق النائية، ما أدى إلى نزوح المواطنين من القرى إلى العاصمة وأطرافها وما ترتب عن ذلك من ظهور الأحياء العشوائية وضغط على البنى التحتية وغيرها من الأمور... يمكننا القول إنه من الطبيعي أن تكون العاصمة والـمناطق القريبة منها أكثر نـمواً من الـمناطق البعيدة عنها، لكن من غيـر الطبيعي أن يبلغ التفاوت فـي التنمية بين الـمناطق حداً كبيـراً. إذ يشمل مفهوم الإنـماء الـمتوازن مضمون عملية التنمية وبُعدها الـجغرافي في آن معاً. لكي تكتمل عملية التنمية، يجب أن تشمل النواحي الاقتصادية والتربوية والاجتماعية، فيؤدي الإنـماء الـمتوازن إلى ترسيخ الوحدة الوطنية، فيشعر أبناء الوطن، بـمختلف مناطقه، أن الدولة تـحتضنهم وترعى شؤونـهم، كما يتقلص التفاوت في الـمستوى الاجتماعي بيـن أبناء الـمناطق. وهذه أمور تؤدي إلى زيادة تـماسك النسيج الوطنـي. إذ نص اتفاق الطائف عام 1989على ما يأتي: «الإنـماء الـمتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام». وبعدها عُدل الدستور بالقانون الدستوري الصادر في عام 1990 وأُدخل هذا النص حرفياً في مقدمة الدستور وشكّل البند (ز) من هذه الـمقدمة. وقد اعتبـرت مقدمة الدستور، في قرارات الـمجلس الدستوري، جزءاً لا يتجزأ من الدستور.
إن إدراج الإنـماء الـمتوازن في الدستور، يعنـي أن الدولة اللبنانية أعطت لهذه القضية أولوية لكي تكون المناطق كلها بذات المستوى الإنمائي من دون أي تمييز، غيـر أن مؤسسات اللامركزية الإدارية تبقى لوحدها عاجزة عن تـحقيق الإنـماء الـمتوازن، نظراً إلى تواضع إمكاناتـها. فهذه العملية تتطلب إنشاء بنـى تـحتية متطورة في مـختلف الـمناطق بـما فيها الـمناطق النائية، وربط هذه الـمناطق ببعضها بشبكة طرق حديثة، وتنمية الـمناطق اقتصادياً عن طريق تطوير الزراعة والعمل على إيـجاد مناطق صناعية في مـختلف الـمدن. وهذا يتطلب رسم سياسات على مستوى السلطة الـمركزية وتنفيذها. لذلك لا يـمكن للسلطة الـمركزية أن تتخلى عن دورها في تـحقيق الإنـماء الـمتوازن، وتترك هذه الـمهمة للإدارة الـمحلية القائمة في إطار اللامركزية الإدارية.
تتجلى تـجربة لبنان في مـجال اللامركزية الإدارية وتـحديداً في البلديات، إذ نرى أن الـمرسوم الاشتراعي الرقم 118/1977 والذي يحكم عمل البلديات، قد منحها صلاحيات واسعة، إذ لا ينحصر عملها في إطار الـخدمات العادية والضرورية فقط، بل يتجاوزها إلى كل ما له علاقة بالتنمية الشاملة على الـمستوى الـمحلي (المادة47 – 48).
أما (الـمادة 49)، فقد عددت الـمهمات التي يتولاها الـمجلس البلدي على سبيل الـمثال لا الـحصر، ذلك أن هذه الـمهمات ترتبط بكل ما له علاقة بالـمنفعة العامة. وإضافة إلى الـمهمات الـمتعلقة بشق وتعبيد الطرقات والنظافة والبيئة والتنظيم الـمدني والتجميل وغيـرها، أنيطت بالـمجالس البلدية مهمات أخرى ترتبط مباشرة بالتنمية الـمحلية بـمفهومها الواسع، فقد نصت (الـمادة 50) من الـمرسوم الاشتراعي الرقم 118 على أنه يـجوز للمجلس البلدي ضمن منطقته أن ينشئ أو يديـر بالذات أو بالواسطة أو يسهم أو يساعد في تنفيذ الأعمال والـمشاريع الآتية: الـمدارس الرسـمية ودور الـحضانة والـمدارس الـمهنية، الـمساكن الشعبية والـحمامات والـمسابح والـمستشفيات العمومية والـمصحات والـمستوصفات والـمتاحف وغيرها...
ورغم هذه الصلاحيات الـمعطاة للبلديات، لـم تتمكن هذه الـمجالس من القيام بـمعظم الـمهمات الـموكلة إليـها، وذلك بسبب ضعف مواردها الـمالية، وعدم إعداد الـجهاز البشري العامل فيها كما يجب، والقيود الـموضوعة عليها في إطار الرقابة من قبل السلطة الـمركزية والتي تؤثر سلباً في عملها. كما إن تأجيل الانتخابات البلدية بشكل متكرر عطّل عمل هذه المجالس وشلّها. لذا لم تلعب البلديات دورها المفترض على صعيد الإنماء المتوازن الذي لا يزال شعاراً يطرح كل مرة في التداول السياسي فقط. وظل حال المناطق على ما هو عليه، وظلت العاصمة مركز الجذب الرئيسي لكل مواطن حُرمت منطقته من الإنماء.
ونظراً إلى أهمية الإنـماء الـمتوازن، بالنسبة إلى أبناء الـمناطق والوطن، بسبب تأثيره الـمباشر في الوحدة الوطنية والاستقرار، فالواجب الوطني يقضي بوضع خطة لتحقيقه من السلطة الـمركزية وتـمويلها وتنفيذها وإعطاء دور فيها للإدارات القائمة في إطار اللامركزية الإدارية. كما ويستلزم قرارات سياسية واضحة وجريئة تجعل من تطوير المناطق المحرومة أولوية تمكّنها من مجاراة المناطق الأخرى تنمويّاً (كتصنيف المناطق على أسس اجتماعية غير طائفية، تشكيل مجالس تخطيط إنمائية فعالة، توسيع نطاق العمل البلدي وتنفيذ المشاريع ومحاربة الفساد، والتخطيط الشفّاف والجدي لتمويل العملية الإنمائية عبر مصادر محلية وخارجية، وإعادة النظر في النظام الضريبي، وتفعيل مفهوم المحاسبة...). عندها يصبح التكامل بين الموارد في القطاعات الإنتاجية المختلفة امراً واقعاً ويؤسس لدولة جديدة قوامها الإنماء والعمل على تأمين احتياجات المواطن وبالتالي تعزيز فكر المواطنية، ولعل هذه الانتخابات البلدية تخطو خطوة الألف ميل في عالم الإنماء ونبذ الحرمان.
أماني المقهور








 عون يدين الاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بتحرك دولي عشية اجتماع الميكانيزم
عون يدين الاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بتحرك دولي عشية اجتماع الميكانيزم  غارة إسرائيلية تستهدف المنطقة الصناعية جنوب صيدا في جنوب لبنان وتوقع جريحين من العمال
غارة إسرائيلية تستهدف المنطقة الصناعية جنوب صيدا في جنوب لبنان وتوقع جريحين من العمال  لبنان: توغل إسرائيلي شمال بلدة حولا وتفجير منزل بمحاذاة بلدة مركبا
لبنان: توغل إسرائيلي شمال بلدة حولا وتفجير منزل بمحاذاة بلدة مركبا  الأسدي: قوات الأمن الفلسطيني تسلّم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل في مخيم عين الحلوة
الأسدي: قوات الأمن الفلسطيني تسلّم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل في مخيم عين الحلوة